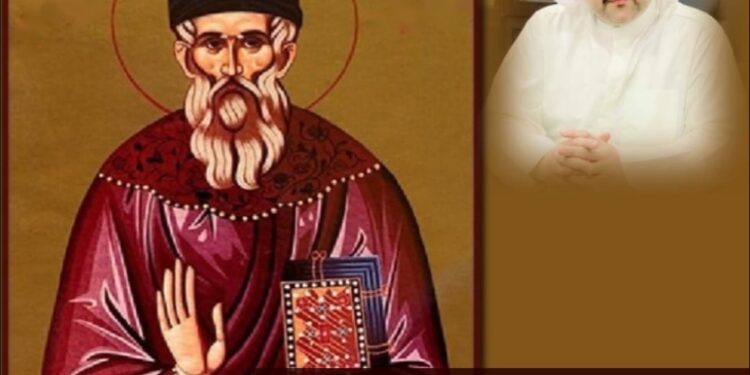ينتقد البعض عندما يعمل أي شخص في سبيل نصرة شعبه ودينه وأمته، ولأني عربي أولاً وأخيراً، ولأني ابن هذه الأمة الإسلامية، لا أفرق بين دين ودين، ولا أنتقد إلا عندما يتوجب النقد، وكما لدينا علماء مسلمون، تبين أن هناك علماء من الديانة المسيحية لا يقلون أهمية وإن كان على مستوى الدين المسيحي، لكن العلم كان قوياً، وكانت الإرادة قوية فكم نحتاج اليوم إلى ثورة الإرادة لإنعاش أرواحنا الميتة فعلاً.. لكن الشهيد يوسف الدمشقي مثال قوي على ذلك.
كان الأب يوسف موهان الحداد؛ وهو ابن جورج موسى حفيد محان الحداد، الشهير باسم يوسف الدمشقي، يحب أن يقدم نفسه كرجل من أصول بيروتية، وموطنه دمشق، وعقيدته الأرثوذكسية، غادر والده بيروت في الربع الأخير من القرن الثامن عشر واستقر في دمشق حيث عمل نساجاً وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء، هم: موسى وإبراهيم ويوسف، تعود أصول العائلة إلى الغساسنة، حيث انتقل أجداد والد يوسف إلى قرية الفرزول اللبنانية في القرن السادس عشر، ومنها إلى بسكنتا في جبل لبنان، ومن ثم إلى بيروت.
ولد يوسف الدمشقي في مايو 1793، لعائلة فقيرة ولكن تقية، تلقى في سن مبكرة بعض التعليم، أي تعرف على الكتابة العربية وقليلاًعلى اللغة اليونانية، حينها قرر والد يوسف، الذي لم يعد قادراً على دفع تكاليف تعليمه، أن يقطع دراسة ابنه، ليكلفه بالعمل في الحرير، لكن الفقر لم يقمع تعطش يوسف للمعرفة، ووجد مخرجاً لهذا الوضع، فقد كان يعمل طوال النهار ويدرس بمفرده في الليل،ربما، مثال أخيه الأكبر موسى، وهو رجل جيد القراءة ويعرف العربية جيداً، أثار هذا التعطش للمعرفة في يوسف، فقد كان لدى موسى مكتبة منزلية صغيرة، والكتب التي أراد يوسف أيضاً التعرف عليها؛ لكن لسوء الحظ، في سن الخامسة والعشرين، غادر موسى هذا العالم؛ قالوا إنه مات لأنه أنهك نفسه في دراسته، تسببت هذه المحنة في تشكك والدي يوسف في أنشطته، لكن التعطش للمعرفة ظل يعيش في قلب يوسف.
بدأ يوسف البالغ من العمر 14 عاماً في قراءة كتب أخيه، لكنه أصيب بخيبة أمل لأنه لم يتمكن من فهم سوى القليل مما قرأه، ومع ذلك، فإن هذا حفز فقط تصميمه، فقال في نفسه: أليس أصحاب هذه الكتب مثلي، فلماذا لا أفهم هذه الكتب؟ ويجب أن أفهم معناها، ثم درس على الشيخ الدمشقي المسلم محمد العطار، أحد كبار علماء عصره؛ قام بتعليم القديس يوسف اللغة العربية والمنطق، لكن اضطر يوسف إلى قطع دراسته مرة أخرى، إذ كان من الصعب على والده دفع تكلفة الدروس والكتب، فاضطر الشاب إلى العودة إلى أسلوب حياته السابق، العمل نهاراً والتعليم الذاتي ليلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن التعليم المدرسي كان آنذاك مرتبطاً بشكل مباشر بالإيمان واللاهوت، ويجب ألا ننسى أيضاً أن الكتاب المقدس كان دائماً أهم كتاب مدرسي، فقد كرّس يوسف كل أمسياته لدراسة العهدين القديم والجديد، ومقارنة النص اليوناني للترجمة السبعينية بالترجمة العربية حتى وصل إلى الكمال في الترجمة من اليونانية، لم يدرس اللغة اليونانية فحسب، بل حفظ أيضاً معظم الكتاب المقدس، لقد استغل كل فرصة لاكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة. درس يوسف اللاهوت والتاريخ على يد جورج شحادة صباح، ثم بدأ بالتدريس خارج البيت، وتعلم العبرية على أحد تلاميذه اليهود.
أثار هذا العمل الشاق الخوف لدى والديه، وحاولا ثني القديس يوسف عن مواصلة الدراسة والتدريس، خوفاً من أن يلقى نفس مصير أخيه، وبعد أن فشلوا في إقناعه، اتخذوا قراراً آخر: فزوجوه فتاة من دمشق اسمها مريم القرشي عندما كان عمره 19 عاماًفقط، لكن الزواج لم يشغله عن طلب العلم.
الكاهن
بعد أن سمعت عن سمعة يوسف الطيبة، لجأت رعية الكنيسة في دمشق إلى البطريرك سيرافيم (1813-1823) لطلب جعل يوسف كاهناً، رسمه البطريرك شماساً ثم كاهناً في أسبوع واحد – وكان عمر القديس يوسف في ذلك الوقت 24 عاماً فقط، فقد اعترف البطريرك التالي، ميثوديوس (1824-1850)، بتقوى يوسف ومعرفته وشجاعته، ومنحه رتبة رئيس الكهنة.
وفي نهاية القرن التاسع عشر، بعد 39 عاماً من وفاة الشهيد، ومما يتردد صدى هذه المواعظ ما قاله في بداية القرن العشرين الكاتب الملكي حبيب الزيات، من أن القديس يوسف كان مشهوراً بين العرب بعلمه ووعظه، يمكن التعرف بسهولة على خطبه من خلال الأدلة المقنعة والحجج الدامغة، وبحسب عيسى إسكندر المعلوف، كان للقديس يوسف صوت هادئ، لكنه كان يُسمع عن بعد، وكان الناس يستمعون إليه بلهفة وفرح ورغبة في اتباع نصائحه والوفاء بعهوده.
وكان أيضًا غيوراً في تعزية الحزانى ومساعدة الفقراء والضعفاء،في عام 1848، عندما تفشت الحمى الصفراء في دمشق، كان الأب يوسف يعتني بالمرضى ويدفن الموتى، دون خوف من الإصابة بعدوى خطيرة، لأن إيمانه كان عميقاً وقوياً، لقد أخذ هذا المرض أحد أبنائه، لكنه استمر في أداء واجباته كراعٍ بنفس التفاني، وكان يحظى باحترام كبير من أهل دمشق الذين رأوا فيه صورة القديس بولس الذي قال: “نحن مظلومون في كل مكان ولكن غير مظلومين،نحن في ظروف يائسة، ولكننا لا نيأس؛ نحن مضطهدون، لكن غير متروكين؛ لقد طرحنا ولكننا لا نهلك..”.
كما بذل الكثير من الجهود لإبعاد الناس عن العديد من التقاليد غير الأرثوذكسية أثناء الخطوبة وحفلات الزفاف والجنازات، وكان خبيراًليس فقط في البناء الروحي، بل أيضاً في مسألة بناء الكنائس،وفي عام 1845، قام بترميم كنيسة القديس نقولا بجوار الكاتدرائية البطريركية، والتي للأسف دمرتها النيران بالكامل خلال أحداث عام 1860 الرهيبة.
المدرسة البطريركية
لم يعد من الممكن تحديد من أنشأ المدرسة البطريركية في دمشق بالضبط، ولا متى تم إنشاؤها، يعلم الجميع أنه في القرن التاسع عشر ارتبطت المدرسة ارتباطاً وثيقاً باسم الأب يوسف، لذلك اشتهرت بمدرسته، وبعد أن ترأس المدرسة عام 1836، جمع الأب يوسف تلاميذها مع تلاميذه، ولم يدخر جهداً في تطويرها، فقد تم إنشاء مجلس المدرسة، وكان يحصل المعلمون على رواتب منتظمة،كل هذا أدى إلى بدء توافد الطلاب من جميع أنحاء سوريا ولبنان إلى المدرسة.
لقد استطاع أن يبعث في تلاميذه روح السلام والثقة في الصلاح التي هي سمة القديسين، وانتشرت هذه الروح التقية، كما في سلسلة، من تلاميذه وخريجيه إلى جميع معارفهم وزملائهم وأصدقائهم، وهكذا انتشر تعليمه على نطاق أوسع وأتى تعليمه بثمار جيدة.
شخصية القديس
كانت إحدى السمات الشخصية الرئيسية لهذا الراعي والمعلم هي عدم المبالاة، وتقول بعض المصادر أنه لم يتقاضى راتباً من الكنيسة، وبفضل سمعته الطيبة، تلقى الأب يوسف دعوة من كيرلس الثاني، بطريرك القدس (1845-1872)، لتدريس اللغة العربية في مدرسة كنيسة القدس (المصلبة)، فرفض ذلك، وقال: “دُعيت للخدمة في دمشق؛ والذي دعاني إلى هذا هو يرضيني”.
لقد كان مؤمناً حقيقياً، صادقاً في الإيمان، صبوراً على نحو غير عادي، صالحاً، وديعاً، هادئاً، متواضعاً، كان لا يحب التحدث عن نفسه ويشعر بالحرج عندما يسمع مديح الآخرين، ولا يعرف كيف يرد عليهم، وكان حكيماً وصبوراً في رعايته، عندما كان يتجادل مع العلماء كان يتحدث لغتهم، وعندما يقنع الناس العاديين كان يتحدث بلغتهم.
أما عن أعماله، لم تؤكد المصادر حجم مكتبته بسبب الحريق الذي التهم كل شيء العام 1860، لكن
أعمال الأب يوسف عديدة: لقد قام بتوثيق سفر المزامير وكتاب الأدعية ورسائل الرسل بالأصل اليوناني، وقام بترجمة التعليم المسيحي للقديس فيلاريت مطران موسكو إلى اللغة العربية، وكان عند نسخ المخطوطات يقارنها بغيرها ويصححها؛ وكانت نسخه موثوقة، وقام بتحرير ترجمة أحاديث سفر التكوين للقديس باسيليوس التي قام بها الشماس عبد الله الفاضل الأنطاكي، كما قام بتحرير 30 عظة للقديس غريغوريوس اللاهوتي، وعادة ما ينهي المخطوطة على النحو التالي: “هذا الكتاب منسوخ من مخطوطة قديمة ويتوافق معها بالكامل”، ويضع ختمه.
وقد اعتمدت جميع دور الطباعة الأرثوذكسية، مثل دار مارجرجس في بيروت، وكنيسة القيامة في القدس، والمطابع العربية في روسيا، على الأب يوسف في تحرير الكتب وجمعها وقراءتها، وفي اللاهوت والأدب والعلوم الإنسانية، أصبح ختمه ختم الثقة، وقد ساعده في الترجمة من اليونانية إلى العربية ومن الإنجليزية إلى اليونانية ياني بابادوبولوس، كما ساهم الأب يوسف بشكل كبير في تحرير الترجمة العربية للكتاب المقدس الصادرة في لندن، كما أن جميع المسودات التي أعدها فارس الشدياق ولي، صححها الأب يوسف بعد مقارنتها بالنصوص اليونانية والعبرية.
بالتالي، إن مساهمته في الأدب هي الموثوقية والدقة، لأنه كان يعاني دائماً من الأخطاء المطبعية، ولم تذكر المصادر كما أسلفتشيئاً عن أعماله، ربما باستثناء القليل من مقالاته، وبالتالي اقتصر على ترجمة أعمالهم وتحريرها وتقديمها للمؤمنين في شكل تراث نقي ونقي ودقيق تماماً.
الأب يوسف والملكيون
في العصر الذي عاش فيه الأب يوسف، كانت مشكلة محاربة الملكيين الذين ابتعدوا عن الكنيسة الأرثوذكسية مؤخراً، هي الأصعب لجميع المؤمنين، في ذلك الوقت، كانت كل الجهود تهدف إلى ضمان عودة المنشقين إلى حضن الكنيسة، وفي حل هذه القضية اتبع البعض طريق الضغط السياسي والإداري، بينما اتبع البعض الآخر طريق التوصل إلى اتفاق متبادل، وكان الأب يوسف ينتمي إلى الأخير.
كان يكره العنف ولم يسمح حتى بفكرة تقديم شكوى إلى حكام الدولة العثمانية ومساعدتهم في قمع الملكيين، واعتبر أن ذلك، أسلوب غير منتج؛ لن يؤدي إلا إلى زيادة الانقسام.
بالتالي، لا شك أن الأب يوسف كان في القرن التاسع عشر أعظم شخصية في الكنيسة الأنطاكية، لقد كان هذا وقتاً صعباً بالنسبة إلى أنطاكية، فقد أدى الانشقاق الملكي إلى وضع حرج للغاية في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الرعوي، حيث كان المبشرون البروتستانت نشيطين وعدوانيين للغاية، وكانت الكنيسة ضعيفة وضعيفة وجاهلة وفقيرة، منذ عام 1724، كان الكهنة غريبين عن هذه الأرض وتطلعات شعبها، وأصبحت أنطاكية رهينة الرأي القائل بأنها ستضعف تماماً قريباً وتنتقل إلى الروم الكاثوليك، ونيابة عن الأرثوذكسية كلها، تقاسمت القسطنطينية وأورشليم فيما بينها صلاحيات تعيين أساقفة الكنيسة الأنطاكية وتحديد مصيرها، في ذلك الوقت لم يكن هناك كهنة أكفاء ولا رعاية رعوية جادة، يمكن تشبيه الكنيسة الأنطاكية في تلك الفترة بسفينة أصيبت بأضرار بالغة في عاصفة وكادت أن تغرق، وفي وسط هذه المشاكل والمخاطر، مثل غصن صغير، ازدهرت تقوى الأب يوسف، واهتم كثيراً بالتعاليم الدينية.
وفي 9 يوليو 1860، عندما بدأت أعمال الشغب في دمشق، لجأ العديد من المسيحيين إلى الكاتدرائية البطريركية (المريمية)؛ بعضهم جاء من مدينتي حاصبيا وراشيا اللبنانيتين، حيث بدأت المذبحة ووقعت حتى جرائم قتل، أما البقية فقد جاءوا من القرى المحيطة بدمشق، وفي صباح 10 يوليو، اقتحم الغاضبون الكاتدرائية وبدأوا قتل من فيها ثم إشعال النار فيها، قُتل كثيرون، واندفع الباقون إلى الشارع؛ وكان من بينهم الأب يوسف، الذي قتل وتم التنكيل بجسده، لينال إكليل الاستشهاد.
ربما قرأ الكثير عن قصة الشهيد يوسف، ففي كل زمان هناك يوسف، ويجب أن يكون هناك أشخاصاً، تنشر العلم وتحقق فيه، فكما في الإسلام برع محققون وكانوا ثقة واعتمدوا أساليب الجرح والتعديل وعلم الرجال، أيضاً هناك من درس الأديان الأخرى منعاً من انحرافها، لكن الغريب أنه بدلاً من إحياء مظاهر هجينة ودخيلة على مجتمعاتنا بما في ذلك المسيحيين منهم، لماذا لا يتم إحياء هكذا شخصيات والتعرف على مسيرة حجها الصعبة ونصرتها للمظلوم والفقير، بدلاً من ممارسة طقوس لم تكن يوماً من عادات وتقاليد الشعوب المشرقية والشرقية.. بكل الأحوال استمتعت جداً في تنقيبي المتواضع عن هذه الشخصية التي تؤكد أن بلادنا كانت زاخرة بالعلماء ومن كل الأديان وفي كل المجالات.
عبدالعزيز بن بدر القطان/ كاتب ومفكر – الكويت.