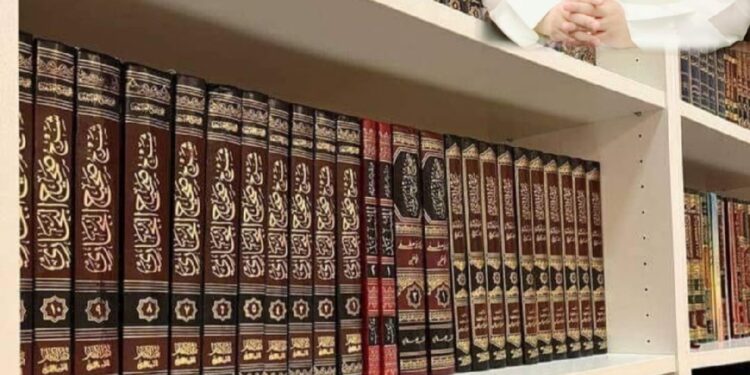لم تُصنَع عظمة السنة النبوية عبر التاريخ بضجيج الشعارات ولا بسطوة التقديس الأعمى، وإنما تشكّلت عبر مسار طويل من الوعي العلمي الصارم الذي أدرك أن النص المقدس لا تحميه العاطفة وحدها، بل تحرسه العقول التي تمتلك الجرأة على السؤال، والأمانة في النقد، والخشية من الله قبل خشية الناس.
وفي هذا المسار الشاق، الذي تداخل فيه الحفظ بالفهم، والرواية بالدراية، يبرز الإمام علي بن عمر الدارقطني بوصفه واحدًا من أخطر العقول النقدية التي أنجبتها الحضارة الإسلامية في تعاملها مع الحديث النبوي، لا لأنه أكثرهم رواية، ولا لأنه أشهرهم تصنيفًا، بل لأنه بلغ في علم العلل منزلة جعلت كلامه معيارًا، وحكمه ميزانًا، ومنهجه طريقًا لا غنى عنه لكل من أراد أن يفهم كيف صينت السنة من الداخل.
وُلد الدارقطني في بغداد سنة 306 للهجرة، في مدينة لم تكن مجرد حاضرة سياسية، بل كانت مختبرًا فكريًا مفتوحًا تتقاطع فيه المدارس والمذاهب والاتجاهات. بغداد ذلك الزمن لم تكن بيئة استقرار معرفي، بل كانت ساحة سجال دائم حول النص، وحول حدود العقل، وحول علاقة الحديث بالفقه والكلام. في هذا الجو المشحون، تشكّل وعي الدارقطني، لا بوصفه تابعًا مقلدًا، بل بوصفه ابنًا شرعيًا للتراث الحديثي في أكثر مراحله نضجًا وتعقيدًا، فقد جاء بعد مرحلة الجمع الكبرى، وبعد أن استقرّت الصحاح والسنن، وبعد أن تشكّلت حول بعض الكتب هالة من الهيبة العلمية التي كادت تتحول، عند غير المتخصصين، إلى نوع من العصمة الضمنية.
لكن الدارقطني لم يرَ في هذا الاستقرار نهاية الطريق، بل بدايته. فقد أدرك، بوعي العالم العارف بتاريخ علمه، أن اكتمال التدوين لا يعني اكتمال الفهم، وأن كثرة الروايات لا تعني بالضرورة سلامتها من العلل الخفية. ولذلك انصرف، منذ وقت مبكر، إلى أخطر أبواب علم الحديث وأدقها: باب العلل، ذلك الباب الذي لا يدخله إلا من تشبع بالأسانيد حتى صارت له حسًّا داخليًا، ومن تمرّس بالروايات حتى بات يميّز اضطرابها كما يميّز الطبيب الخلل في الجسد الحي.
ولم يكن الدارقطني عالمًا منعزلًا في محرابه، بل كان ابن مدرسة نقدية عريقة، تلقى عن كبار الشيوخ، وطاف في طلب الحديث، وجمع الطرق، ووازن بينها، حتى صار عقله مستودعًا هائلًا للتفاصيل الدقيقة التي لا يلتفت إليها إلا القلة. ومع ذلك، فإن ما ميّزه حقًا لم يكن حجم محفوظاته، بل طبيعة تعامله معها. لم يكن يتعامل مع الحديث كنص مغلق، بل كنص مفتوح على الاحتمال، وعلى الخطأ البشري، وعلى تعقيدات النقل. ولذلك كان شديد التحرز في أحكامه، دقيقًا في عباراته، لا يطلق الحكم إلا بعد استيفاء النظر، ولا يتسرع في التضعيف ولا في التصحيح.
وقد شهد له معاصروه ومن جاء بعدهم بهذه المنزلة الرفيعة. قال الحاكم النيسابوري، وهو من أعرف الناس بمقامات أهل الحديث: “الدارقطني إمام أهل الحديث في زمانه”، وقال أيضًا: “لم يُرَ في عصره أحفظ منه ولا أعلم بعلل الحديث”. وهذه الشهادة، حين تصدر من الحاكم، لا يمكن قراءتها على أنها مجرد ثناء، بل هي توصيف دقيق لمكانة علمية استثنائية. وقال الخطيب البغدادي: “كان الدارقطني أحد أئمة المسلمين، انتهى إليه علم الأثر ومعرفة علل الحديث وأسماء الرجال”، وهو وصف يكشف عن طبيعة الدور الذي اضطلع به الدارقطني، بوصفه خاتمة مرحلة من النضج النقدي العالي.
إلا أن أخطر ما في تجربة الدارقطني، وأكثر ما أثار حوله الجدل، هو موقفه من صحيحي البخاري ومسلم. ففي زمن بدأت فيه هالة “الصحيحين” تترسخ في الوعي العام، تعامل الدارقطني معهما بعقلية العالم لا بعقلية المقلد. لم ينكر مكانتهما، ولم يطعن في جلالة صاحبيهما، لكنه رفض أن يتحولا إلى نصين خارج دائرة البحث العلمي. فكتب “الاستدراكات والتتبع”، لا ليهدم، بل ليكمل، ولا ليشكك، بل ليُعلّم كيف يكون النقد العلمي المنضبط. وهذا ما يجعل كتابه هذا من أخطر الكتب في تاريخ علم الحديث، لأنه كسر حاجز الرهبة، وأعاد النص إلى سياقه البشري دون أن ينزع عنه قدسيته.
وقد فهم كبار العلماء هذا المنهج على حقيقته، فلم يروا في نقد الدارقطني تهديدًا للسنة، بل حماية لها. قال ابن تيمية: “الدارقطني من أعلم الناس بالحديث وعلله، وكلامه في ذلك معتمد عند أهل العلم”، وهذه العبارة بالذات تكشف عن مكانة الدارقطني في ميزان أهل التحقيق، إذ لم يكن ابن تيمية ممن يجامل في مثل هذه المواطن. كما قال الذهبي: “الإمام، الحافظ، الناقد، علم العصر”، وهو وصف يجمع بين الحفظ والنقد، بين الكم والكيف، ويضع الدارقطني في موقع فريد بين أئمة الحديث.
منهج الدارقطني في النقد الحديثي يقوم على إدراك عميق لطبيعة الرواية البشرية. كان يعلم أن الثقة قد يخطئ، وأن الخطأ لا يعني الكذب، وأن سلامة الإسناد الظاهرة لا تمنع وجود علة خفية في المتن أو في السياق. ولذلك كان نقده مركّبًا، لا يكتفي بحكم واحد، بل يبني حكمه على شبكة معقدة من الاعتبارات: اختلاف الطرق، حال الراوي في مراحل عمره المختلفة، مدى ضبطه في هذا الحديث بعينه، ومقارنة روايته بروايات أقرانه. وهذا النوع من النقد لا يمكن أن يُختزل في قواعد جامدة، بل هو ملكة عقلية تُكتسب بالممارسة الطويلة، وهو ما جعل الدارقطني مرجعًا لا يُستغنى عنه.
ولم يكن الدارقطني متشددًا متصلبًا، كما قد يتوهم بعض من يقرأ أحكامه دون فهم سياقها، بل كان واعيًا بحدود العلم البشري. كان يدرك أن كثيرًا من مسائل العلل لا تُحسم حسمًا قاطعًا، وأن الترجيح فيها هو أقصى ما يمكن بلوغه. ولذلك جاءت أحكامه غالبًا بصيغة العالم المتحفظ، لا القاضي المتعجل. وهذه الروح العلمية هي التي حفظت لعلم الحديث توازنه، ومنعته من الانزلاق إلى أحد طرفي الإفراط أو التفريط.
ورغم هذا الوزن العلمي الهائل، لم يكن الدارقطني نجمًا جماهيريًا، ولم يسعَ إلى صناعة مدرسة تحمل اسمه، ولم يترك مؤلفات تعليمية مبسطة للعامة. كتب للنخبة، وخاطب المتخصصين، وتحرك داخل الدائرة الضيقة للعلم الدقيق. وربما كان هذا أحد أسباب غيابه النسبي عن الوعي العام، مقارنةً بأسماء أخرى أكثر حضورًا في المناهج والكتب المختصرة. فالتاريخ، في كثير من الأحيان، يكافئ من يقدّم العلم في صورة سهلة، أكثر مما يكافئ من يحرسه في مستوياته العميقة.
لكن أثر الدارقطني الحقيقي لا يُقاس بعدد من قرأوه، بل بنوعية من تأثروا به. فكل من جاء بعده في علم العلل، من قريب أو بعيد، كان يتحرك في المساحة التي رسمها، ويستفيد من الأدوات التي صقلها. لقد أسهم في ترسيخ فكرة أن علم الحديث ليس مجرد نقل، بل هو نقد وتحليل وفهم، وأن حماية السنة لا تكون بإغلاق باب السؤال، بل بإحكام أدواته.
ولو أُعيد استحضار منهج الدارقطني في زمننا المعاصر، لوجدنا فيه ضالة مفقودة. ففي عصر يتنازع فيه خطابان متطرفان؛ خطاب يرفض السنة باسم العقل، وخطاب يقدّس كل ما نُسب إلى الحديث دون تمحيص، يقدّم الدارقطني نموذجًا ثالثًا، يقوم على النقد من داخل التراث، وعلى احترام النص دون تعطيل العقل. لم يكن لينحاز إلى دعاة الإنكار، ولا إلى دعاة التساهل، بل كان سيطالب بالسؤال المنهجي، وبالأداة العلمية، وبالتمييز بين الثابت والمختلف فيه.
إن الدارقطني، في جوهر تجربته، يمثل قمة النضج في علم الحديث، حين بلغ هذا العلم وعيه بذاته، وأدرك حدوده وإمكاناته. لم يكن مشروعه هدمًا، بل تصويبًا، ولم يكن نقده عدوانًا، بل أمانة. وحين ننظر إليه اليوم، لا ينبغي أن نراه مجرد اسم في كتب التراجم، بل نموذجًا للعالم الذي خدم النص بصمت، وحمل عبء الأمانة دون ادعاء، وترك أثره في البنية العميقة للعلم لا في واجهته.
وأخيراً، يمكن القول إن الإمام الدارقطني يجسّد حقيقة كثيرًا ما تُنسى في تاريخ العلوم الإسلامية: أن العقول التي تحفظ التراث ليست دائمًا هي الأكثر شهرة، وأن الحراس الحقيقيين للنصوص المقدسة هم أولئك الذين يملكون الشجاعة على مساءلتها بالمنهج، لا على مصادمتها بالهوى. وبمنهج الدارقطني، لا باسمه فقط، بقي الحديث النبوي علمًا حيًا، متوازنًا، قادرًا على الصمود أمام الزمن، لأن من صانه لم يعبد النص، ولم يفرّط فيه، بل عامله كما يليق بكلام نبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: بعلم، وخشية، ومسؤولية.
عبدالعزيز بدر عبدالله القطان