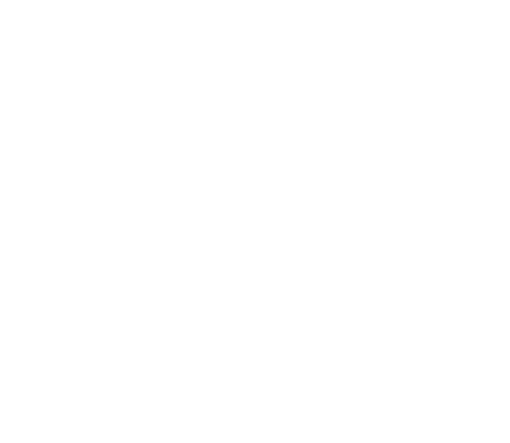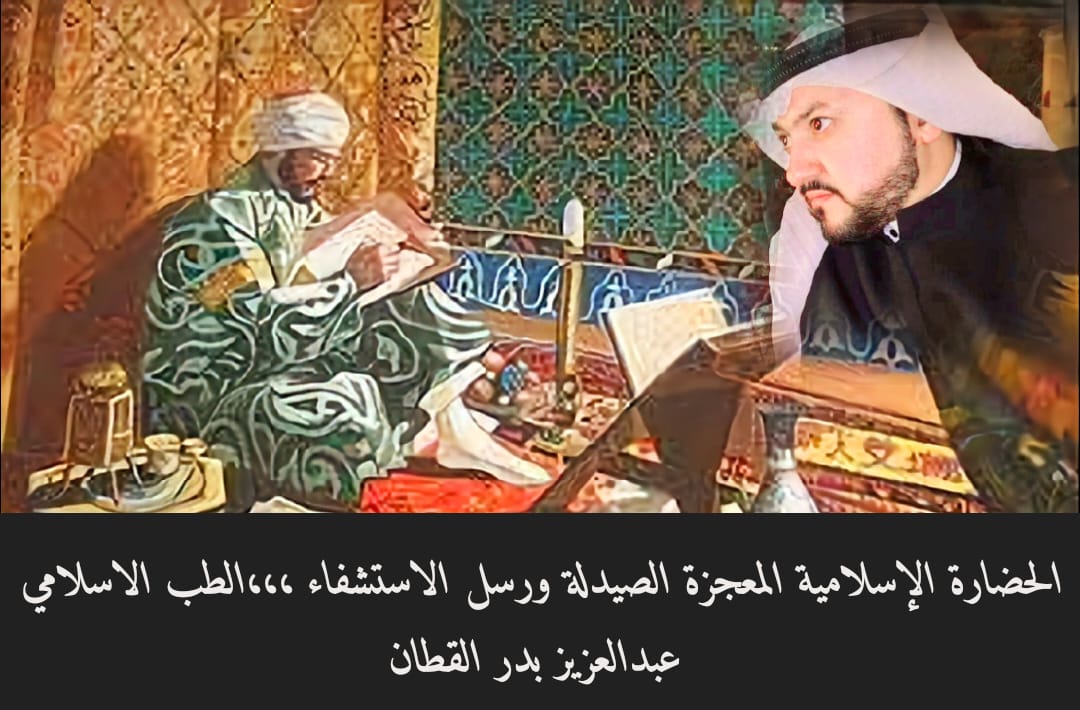لم تكن الحضارة الإسلامية، مجرد حضارة عابرة، وقفت عند حدود زمان ومكان محدد، بل امتدت لتشمل كل مقاصد الحياة، علماً وأدباً وفنّاً أدبياً وحتى عسكرياً، التطورات كانت كثيرة، ومن المُحال حصرها في مقالٍ واحد، لكن نحاول بين الفينة والأخرى، تقديم فنٍ من الفنون، ومآثر العلماء المسلمين الذين أغنوا الحضارة البشرية، فلا حقوق ملكية كما الغرب، لأن الفائدة في الإسلام، هي نفع الجميع دون استثناء، لذلك لنفخر بتراثنا وديننا الإسلامي، لأنه بحق دين السلام الأوحد.
إن الحضارة الإسلامية وبتجرد خالص، من أكثر الحضارات التي تحتاج التأمل والتعمق في التاريخ، ففي سبر أغوارها مهما كنت تظن أنك تعلم، تتفاجأ بالكثير من العلوم وبالكثير من العلماء، وبالكثير من الفوائد التي شكلت أرضية وقاعدة أساسية لما توصلت له البشرية اليوم، وهذا أمر من الممكن ردّه على كل مشكك في هذه الحضارة التي خرجت من رحم الإنسانية السمحاء بتعاليم الإسلام النقية والطاهرة، والتي شكّلت ورسمت منطلقات ما نعيشه اليوم، ويمكن تسميتها بالحضارة المعجزة، لأنها تأسست، وتشكلت، وأخذت صورتها النهائية بشكل سريع جداً ووقت قصير جداً، ويمكن القول إنها اكتملت وبلغت ذروتها حتى قبل أن تبدأ، وهذا كله مسطور في القرآن الكريم، فمن يتأمل ويتدبر هذا الكتاب العظيم ويُبحر في هذا السِفر الكبير، يجد من الومضات العلمية الكثير والتي دعت إلى سمو الإنسان نحو آفاق المعرفة الرحبة التي لا حدود لها، وإلى التدبر والتبصّر وإثارة الذهن وصولاً نحو عِلَل الأشياء، وإلى تطبيق منهجٍ علمي فريد هدفه إقامة حياة متميزة مبنية على أسس سليمة.
وكنا في مقالاتٍ سابقة قد توسعنا بعض الشيء في علوم هذه الحضارة إن كان في الفلك والغوص في أسرار العالم الكبير أبو الريحان البيروني، أو في الرياضيات والتعمق في خوازرميات الخوارزمي، وليس انتهاءً بالطب وبإبداع طبيب الإسلام، ابن سينا، لنبحر اليوم في علم الصيدلة، هذا العلم الذي توصل إليه العلماء المسلمين بما قدمته لهم الطبيعة الغنّاء، فعملوا على فك شيفرة كل نبات وصنع التراكيب التي شكلت بلسماً لتخفيف الأوجاع، فماذا سنعرف عن هذا العلم ومن أشهر من عمل به؟
لم يَقف المسلمون عند حدود الطب النبوي وما جاء فيه من وسائل علاجية ووقائية، مع يقينهم بنفعه وبركته، بل أدركوا منذ وقت طويل أن علم الطب والصيدلة يحتاج إلى دوام البحث والنظر، وإلى الوقوف على ما عند الأمم الأخرى منه، ودفعهم إلى ذلك دعوة الإسلام للاستزادة من كل ما هو نافع ومفيد، والبحث عن الحكمة أنى وُجدت. واشتهرت طائفة من علماء المسلمين بترجمة الكتب المتخصصة بعلوم الطب، ومصادر الأدوية النباتية وخصائصها وطرق تركيبها، فعلى سبيل المثال، قاموا بترجمة كتاب لـ “أرسطو” وتلميذه “ثيوفراستس” المعروف بأبي علم النبات، وأعقب ذلك مرحلة جديدة تناولت التعليق على تلك الكتابات المترجمة، ونقدها وشرحها ودراستها، ليتم بعدها في خطوة تالية إقرار صوابها وتصويب خطئها. وما هي إلا مدة وجيزة، حتى انتقل المسلمون نحو أفقٍ آخر سامٍ من الازدهار العلمي والفكري، وولّوا وجوههم شطر الأصالة والتأليف والإبداع، فأضافوا الجديد والمفيد إلى علمَي الطب والصيدلة، تدفعهم حماستهم التي استشعروا بها التقرب إلى الله تعالى بطلب العلم، وقد عُرفت كتبهم تلك في حينها بـ”الأقرباذينات”.
وهنا لا بد من معرفة القليل عن الطب النبوي وكيف استهدى إليه المسلمون، وفوائده وهل يُعمل به حتى يومنا هذا؟ الطب النبوي هو مصطلح يطلق على مجموعة النصائح المنقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تتعلق بأمور طبية الذي تطبب به ووصفه لغيره، والتي وصلت على شكل أحاديث نبوية بعضها علاجي وبعضها وقائي، لم يستخدم مصطلح الطب النبوي على عهد النبي محمد ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدون إنما ظهرت في شكل أحاديث بدأ تجميعها على يد ابن قيم الجوزية في كتابه “الطب النبوي” وكتاب “زاد المعاد” إلى جانب تقديم كل من الإمامين البخاري ومالك على تجميع تلك الأحداديث ذات الصلة، لا يصنف الطب النبوي ضمن علوم الطب أو بديل عن الاستعانة بالأطباء، فقد حث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على تعلم الطب وعدم التداوي عن جهل، كما ورد عن الرسول الكريم أنه أوصى المسلمون وقتها بالاستعانة بالحارث بن كلدة الذي لقب بطبيب العرب، يعد الطب النبوي هو تعبير مستحدث وظهر في بدايات القرن الرابع الهجري إذ صنف أبو بكر بن السني (364هـ) كتاب “الطب في الحديث”، وصنف أبو عبيد بن الحسن الحراني (369هـ) كتاب “الطب النبوي”، وتوالت المصنفات بعدئذ بهذا الاسم لأبي نعيم الأصبهاني (430هـ) وأبي العباس المستغفري (432هـ) وأبي القاسم النيسابوري (406هـ) وغيرهم، وصولاً إلى القرن الثامن والتاسع الهجريين إذ نجد مصنفات للذهبي (748هـ) وابن قيم الجوزية (751هـ) ثم السخاوي (902هـ) والسيوطي (911هـ) وغيرهم.
أما عن مصطلح (الأقرباذينات)، فكان بمثابة دستور للعقاقير والأدوية، أو دستور الصيدلة أو الأقرباذين ويترجم حرفياً إلى فارماكوبيا، هو عبارة عن كتاب يحتوي على جميع الأدوية المسموح باستخدامها بالإضافة إلى صفاتها وخصائصها وطرق تحضيرها، كما يحتوي على توجيهات لتحديد الأدوية المركبة، هو عمل مرجعي لمواصفات الأدوية الصيدلانية.
وكان أبو حنيفة الدينوري (828 – 896 عالم مسلم وكان نحويا ولغويا، ومهندسا، وفلكيا، أخذ علمه عن العلماء البصريين والكوفيين، وكان راوية للحديث ثقة فيما يرويه، الملقب يشيخ علم النبات)، أول من ألّف كتاباً عن النباتات التي أولاها المسلمون عناية خاصة لما علموا أنها مصدر رئيس لحاجتهم من الأدوية. وعُرف مصنف الدينوري هذا باسم “كتاب النبات”، وقد أتى فيه على ذكر أكثر من ألف نبتة من النباتات الطبية في الجزيرة العربية. واشتهر أبو بكر الرازي بالكتابة في علم الصيدلة ووصف الأدوية، وألّف الكثير من الأقرباذينيات التي عُدّت مراجع أصيلة في مدارس الغرب والشرق على حد سواء. ومن أطباء المسلمين وصيادلتهم أيضاً البيروني صاحب كتاب “الصيدلة في الطب”، وابن الصوري صاحب “الأدوية المفردة”، وابن العوّام الإشبيلي صاحب “الفِلاحة الأندلسية”، أما ابن البيطار فقد ارتحل إلى مالَقة، ومرّاكش، ومصر، وسوريا، وآسيا الصغرى، بحثاً عن النباتات الطبية، فكان يراها بنفسه، ويجري عليها تجاربه، ويذكرها في كتابه “الجامع لمفردات الأدوية والأغذية” الذي كان المرجع الرئيس للصيادلة زمناً طويلاً. وقد جاء فيه ذكر أكثر من ألف وأربع مائة دواء من أصل نباتي، منها أربع مائة عقار لم يسبقه أحد إلى وصفها.
ومن أساليب العلماء المبتكرة في مجال الصيدلة، الطريقة المبتكرة في تحضير العقاقير وتركيبها منها طريقة التقطير لفصل السوائل، وطريقة التنقية لإزالة الشوائب، وطريقة التصعيد لتكثيف المواد المتصاعدة، وطريقة الترشيح لعزل الشوائب والحصول على محلول نقي، وكان من ابتكارات صيادلة المسلمين مزجهم للأدوية بالعسل أو بالسكر أو بعصير الفاكهة، وإضافة مواد محبّبة كالقرنفل، ليصبح طعم الدواء مستساغاً، وجعلهم الكثير من الأدوية في صورة أقراص مُغلفة، وتحضير أقراص الدواء عبر كبسها في قوالب خاصة، وإخضاع الدواء الجديد للتجربة على الحيوان قبل وصفه للمريض للتأكد من سلامته وأمانه، كما اهتموا بزراعة النباتات الطبية، والأعشاب العلاجية في مزارع وُضعت بجوار ما بنوا من بيمارستانات مُدن الدولة المختلفة، واهتموا بجلب بذور تلك النباتات من كل حدب وصوب، وفُرض على كل صيدليات الدولة الإسلامية أن تحوي كتب الأقرباذين، وأن يتوافر فيها أنواع العقاقير المفردة والمركّبة المختلفة، والمواد الخام اللازمة لتحضيرها، سواء كانت نباتية المنشأ أو حيوانية أو معدنية أو كيماوية، كما وجب أن تحوي الصيدلية ما يلزمها من معدّات لتحضير الدواء، كالموازين الحساسة، والأوعية ذات المقاسات المختلفة، وقوالب صناعة الأقراص، بالإضافة إلى سجلات خاصة لتدوين عمليات تحضير الدواء وما يَرِدُ من وصفات الأطباء الدوائية.
لم يقتصر الأمر على هذه النواحي بل تعداها إلى أن أدخل العلماءالمسلمون نظام الحُسبة، ومراقبة الأدوية، فنقلوا بذلك المهنة من تجارة حرّة لا ضوابط لها، إلى مهنة خاضعة لرقابة الدولة. وكان من مهام المحتسِب إجراء جولات تفتيش على حوانيت بيع الأدوية، والتأكد من توافر الدواء فيها، ومتابعة طريقة تحضيره بشكل آمن وبدون غش، والتأكد من أن الدواء لا يباع إلا وفق وصفة طبية، ومراجعة كشوفات تحضير الأدوية. بالإضافة إلى منح تصاريح العمل للصيادلة، وإيقاف عمل من تدعو الحاجة والمصلحة إلى ذلك. وقد كان للمحتسب سجلات يُدوّن فيها أسماء أصحاب الحرف والمهن المختلفة بما فيها أماكن حوانيت الصيادلة، كما قامت الدولة الإسلامية بتوظيف “عميد الصيادلة”، وقد وكّل إليه مهام الإشراف الفني على صيدليات المدينة، وإجراء امتحان للصيادلة ومنحهم الشهادات، وتصريح العمل بممارسة صنعة الصيدلة، بالإضافة إلى إعداد سجلات خاصة للصيادلة. وقد عُدّ عميد الصيدلة هذا، المرجع الأعلى فيما يستجد في ساحة العمل من الأمور المتعلقة بهذه المهنة. وأُلزم الأطباءُ لاحقاً، بكتابة ما يصفون من أدوية لمرضاهم على ورقة خاصة، عُرفت في الشام باسم “الدستور”، وفي العراق باسم “الوصْفة”، وفي المغرب باسم “النسخة”، وكان ذلك من إسهامات المسلمين في إنشاء علم الصيدلة على أسس علمية سليمة.
وكان العصر العباسي، هو العصر الذي شهد التقدم العلمي للعلماء العرب والمسلمين، في جميع المجالات، فقد جاء الإسلام بمفهوم جديد للمرض يختلف عما جاء في الكتب السماوية الأخرى، التي كانت تنظر إلى المرض على أنه عقاب من الله تعالى، كما في العصور الوسطى في أوروبا، أما الإسلام فقد اعتبر المرض أنه قضاء وقدر، وأمر بالبحث عن العلاج، ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار وتطور علم الصيدلة أيضاً، ورود النباتات والزرع في آيات كثيرة في القرآن الكريم، بلغت 112 آية، وردت في 27 سورة، قال تعالى: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس)، بالتالي، كان لاتساع الإمبراطورية الإسلامية الدور المهم والبالغ في تطور هذا العلم من خلال ترحال العلماء إلى أماكن بعيدة واكتشاف الكثير من النباتات المفيدة.
أخيراً وليس آخراً، العلوم بحر واسع خلّده علماء المسلمين في كل الحقول والميادين، يحق لنا أن نفخر في مآثر الأمتين العربية والإسلامية، علماء خلّدها التاريخ، تركت إرثاً ضخماً غيّر نظرة المجتمعات نحو الكثير من الشائعات التي كان يطلقها الملحدون والغوغائيون ممن يتربصون بالدين الإسلامي، فإن كان ثمة تطور في الغرب قديماً وحتى حديثاً إن لم يكن الفضل الأول والأخير للعلماء المسلمين، فمن دون أدنى شك أنهم شركاء وبنسبة كبيرة فيه، الدواء هو خلاص الناس من الآلام، وكل يوم يتطور هذا العلم ويتقدم بما يسهم في اكتشافات جديدة من خلال العقول النابغة التي بعثها الله كرسل للاستشفاء، ونأمل أن تنقشع سحابة الوباء العالمي عن الجيمع وأن يشفي الله تبارك وتعالى كل مريض.
عبدالعزيز بن بدر القطان / كاتب ومفكر – الكويت.