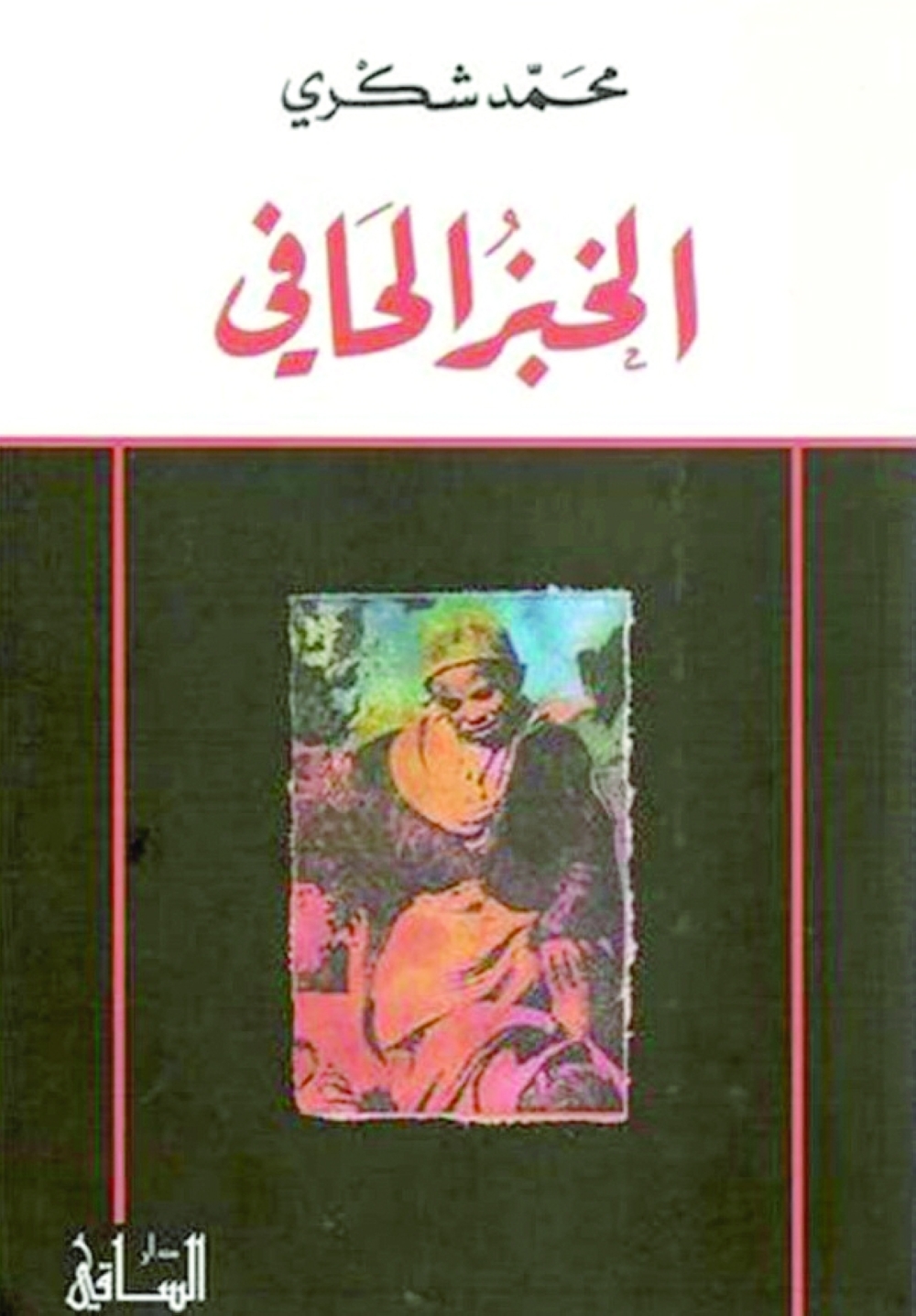كيف يمكنك أن تحول تجربتك (الخاصة) إلى رواية (عامة) يقرأها الجميع، وتذهب بعيدا مع الزمن؟ أو تحول تجربة (غيرك) من الناس إلى رواية تجد اهتماما من القراءة، وتذهب كذلك بعيدا مع الزمن ؟ عربيا فعل ذلك كثيرون، من ضمنهم محمد شكري صاحب الرواية الشهيرة “الخبز الحافي” وشكري لم يكن إلا مثالا على رواية وجدت نجاحا واسعا – خاصة في الغرب الذي يحتفي بكل ما يرسخ أوهام التفوق – هناك كتاب كثيرون يصعب حصرهم، انطلقوا إما من تجاربهم أو من تجارب أشخاص ائتمنوهم على جزء من أسرار حياتهم. مثلا الكاتب اللاتيني ماريو بارجاس يوسا منذ سنوات قريبة كان يبحث عن فكرة لكي يكتب رواية. وكان حاضرا في أمسية ثقافية حين تقدم منه رجل (من العامة) وطلب منه أن يفرغ نفسه ساعة لكي يستمع إليه لأنه يريد أن يحكي له شيئا من حياته. لم يولِ يوسا الذي حاز على جائزة نوبل بسبب رواياته، جزءا كبيرا منها السرد عن حياة آخرين. بل ترك الرجل وشأنه، ولكن الأخير تابعه في أكثر من مكان، مصرا على أن يجعل الكاتب المعروف يستمع إليه. وقد حدث ذلك مرة، ومن خلال تلك الساعة التي سمح بها يوسا لذلك الرجل أن يستمع إليه، تولدت رواية مهمة في مسيرته الأدبية حملت عنوان ” زمن عصيب ” يسرد فيها الراوي جانبا من فترة تعذيب سياسي حدثت في جوانتيمالا، البلد المجهول في أمريكا الجنوبية.
من يقرأ رواية ” العاجز” للكاتب التركي صلاح الدين بولوت، وهي رواية تسرد كذلك جانبا من فترة تعذيب سياسيي غابرة في تركيا، تعود إلى الثمانينات، سيستشعر بوضوح موهبة كاتبها، وبولوت يعمل حاليا في شارع الاستقلال الشهير بإسطنبول، حيث يمتلك مكتبة هناك. صدرت الرواية عن دار كلمة بالإمارات، وترجمها مروان علي بأسلوب رشيق تحولت فيها اللغة العربية إلى قطعة حلوى. في هذه الرواية القصيرة ( ١٢٠ صفحة) يقدم الكاتب صلاح الدين بولوت حالة إنسانية صعبة بأسلوب خفيف ساخر لا يشعر فيه القارئ بأي ملل، بل هو فوق ذلك يتعرف على معلومات جديدة عن الطباع الشرقية المشتركة في مجموعة كبيرة من الأمور، وذلك لأن الطباع الاجتماعية تتحرك في مسار متقارب في مختلف المجتمعات الشرقية فإنها بالقدر نفسه نراها في بلدان أخرى غير ناطقة بالعربية، وإذا كنا مع الروائي التركي أرهان باموق نتعرف – غالبا- على الجزء الغربي من تركيا، أو الجزء المتأثر بالحياة الأوروبية، فإننا مع صلاح الدين بولوت، وتحديدا في روايته “العاجز” نتعرف على وجه شرقي مطابق لحياتنا العربية خاصة في ما يتعلق بالطباع والقفشات الضاحكة التي يقوم بها أب الأسرة مع أبنائه وأحفاده، وقلق الأم المبالغ فيه تجاه عدم زواج ابنها الذي خرج من سجن سياسي. ويتضح كذلك أن الحوار في الرواية الأصلية يدور بين شخوصها باللغة الكوردية وهي إحدى المكونات الثقافية في تركيا، إلا أنه حين نقل للعربية، وبسبب هذا التقارب الثقافي بين المجتمعات الشرقية الزراعية بشكل عام، فإن القارئ ومع تقدم مسار الرواية لا يلبث أن يشعر بحميمية ما يقرأ، وكأنه يعرف عن قرب تفاصيل الرواية أو كأن الحديث هنا عن أخوة له يتحدثون بلسان عربي مبين. وهذا الفرق بينها وبين قراءتنا لرواية أوروبية صرف تدور في فضاء عالم عصري (نتعرف) فيه ونحن نقرأ على طباع تفكير جديدة، بينما في مثل هذه الروايات (نعيش) أكثر مما نتعرف، وذلك بسبب هذا التقارب السيسلوجي الحاصل بين فضاء الرواية وفضائنا الشرقي العربي على أكثر من مستوى وتفصيل، مثل الاهتمامات المشتركة في التربية وأذواق الطعام وطريقة تبادل العواطف والاهتمام بالاستقرار الجماعي وخجل الفتيات ونزوع الفتيان نحو التمرد، وغيرها من تفاصيل تحفل بها الرواية، ناهيك عن الأسماء ذات السمة الشرقية الواضحة. براعة الكاتب أيضا تكشف موهبته في الوصف وتحريك الشخصيات تحريكا لا تشوبه الصنعة وكأنه بصدد مشاهدة فيلم سينمائي ترتسم فيه الحروف سريعا لتشكل صورا مستساغة لا يعترض طريق تشكلها عارض ذهني أو فذلكة لغوية. تروي الرواية أو تسرد حياة شاب يخرج من السجن ويعيش عذابات لا يستطيع الكشف عنها تتعلق بفقدانه القدرة على الزواج، رغم أن فتاة في انتظاره، ابنة جارتهم، تحاول التقرب منه وتقدم له مأكولات يرفض أن يقربها حتى لا يفتح المجال واسعا للعلاقة. وكانت أمه تعاني من أجل تقريب العلاقة بينهما، ولكنه في النهاية يقرر الذهاب إلى إسطنبول تحت دواعي التغيير بعد غياب دام عشر سنوات قضاها في السجن. وفي إسطنبول يتصل بأحد (الرفاق) السابقين الذي يوفر له مناما في جوف معمل النجارة الذي يملكه. تتطور الأحداث انطلاقا من وصوله إلى إسطنبول وهناك يحاول أن يجرب حياة أخرى، تفرعت لتنتهي به إلى الضياع والتشرد. (رواية إنسانية، ممتعة تذكرنا بعيون الأدب).